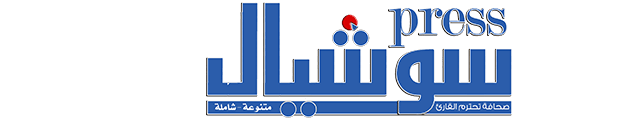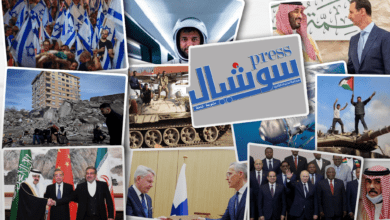يشهد العالم اليوم تصاعدا غير مسبوق في وتيرة النزاعات المسلحة، فقد أشار معهد أبحاث السلام إلى وقوع 61 نزاعا مسلحا في 36 دولة خلال عام 2024، وهو أعلى رقم منذ نهاية الحرب الباردة.
كما وثّق مشروع رصد النزاعات أكثر من 165 ألف حادث عنف سياسي في عام واحد، بزيادة تقترب من 15% مقارنة بالعام السابق، وهذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات جامدة، بل تعبّر عن مآسٍ إنسانية؛ عن أسر مشرّدة ومدارس مدمّرة، وأجيال تنشأ في أجواء الخوف وفقدان الأمل، وما يجري في غزة والسودان وميانمار ليس سوى مثال حيّ على هشاشة النظام العالمي وانهيار منظومة القيم المشتركة.
وأمام هذه الحقائق الصارخة، يصبح واضحا أن تحقيق السلام لا يمكن أن يقتصر على اتفاقات سياسية أو تدخلات عسكرية ظرفية.. إن الحل الجذري يكمن في معالجة البنية الفكرية والنفسية للمجتمعات، أي في إعادة تشكيل وعي الإنسان بعلاقته بذاته وبالآخرين وبالعالم من حوله.. وهنا تبرز التربية كخيار استراتيجي وأداة بنيوية لإحداث هذا التحوّل فالتربية على السلام ليست مادة تكميلية، بل مشروع متكامل لغرس وعي جمعي بأن التعايش خيار عقلاني وضرورة أخلاقية، وأن بناء السلم واجب إنساني يشمل السياسة والاقتصاد والبيئة على حدّ سواء.
ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى صياغة منهجية واضحة للتربية على السلام، بحيث تصبح القيم الكبرى مثل الرحمة والعدالة والتسامح والمصالحة والشورى مرتكزات للمناهج التعليمية وخيطا ناظما للعملية التربوية.. ولا تظل هذه القيم شعارات رنانة، بل تتحوّل إلى معايير سلوك فردي وجماعي.
فالتربية على السلام لا تكتفي بتلقين الفضائل، بل تحوّلها إلى ممارسات عملية تدفع المتعلّم إلى العدل، وتدربه على الحوار، وتكسبه شجاعة البحث عن حلول سلمية للنزاعات ولا تقف الصياغة المطلوبة عند تحديد المضامين، بل تشمل طرق التدريس وآليات التنفيذ.. فالتربية على السلام لا يمكن أن تقدّم في شكل محاضرات نظرية فحسب، بل يجب أن تعاش بالتجربة والممارسة: حوارات بين الثقافات والأديان، محاكاة لحل النزاعات، ومشاريع ميدانية تعالج قضايا المجتمع الواقعية. من خلال هذه التجارب يتحول العلم إلى خبرة، والخبرة إلى سلوك، والسلوك إلى جزء من الهوية الشخصية والاجتماعية، فتتكوّن شخصية قادرة على إدارة الأزمات بوعي ومسؤولية.
وعلى المستوى المجتمعي، تمثّل التربية على السلام أداة لإعادة بناء النسيج الاجتماعي وترميم ما تصدّع منه.. فهي تعزز العدالة الاجتماعية برفع صوت الفئات المهمشة، وتعيد فتح قنوات التواصل في المناطق التي مزقتها الحروب، وتوفّر فضاءات للحوار البنّاء بعد فترات من الانقسام والقطيعة.. وهكذا تصبح التربية على السلام مشروعا لإعادة التوازن الأخلاقي قبل أن تكون برنامجا وقائيا ضد النزاعات المستقبلية.
كما أن البعد البيئي يحتل مكانة أساسية في هذا التصور. فالكثير من النزاعات المعاصرة تدور حول المياه والموارد الطبيعية والبيئة المتدهورة ومن ثمّ، ينبغي أن تتضمن التربية على السلام توعية بيئية تجعل حماية الأرض جزءا من بناء السلم الاجتماعي، ويمكن إدماج برامج التشجير وترشيد استهلاك المياه وإعادة التدوير ضمن الأنشطة المدرسية لترسيخ هذه القناعة في سلوك الناشئة.
وحتى تؤتي التربية على السلام ثمارها، لا بد أن تأتي المناهج شاملة وعابرة للتخصصات، فتجمع بين محو أمية النزاعات، وأخلاقيات التواصل، والوعي العالمي كما يجب أن تتحول قضايا مثل الهجرة والفقر واللا مساواة إلى مادة للتأمل والتحليل النقدي، ليكتسب المتعلمون القدرة على الربط بين الظلم الاجتماعي وتفجّر العنف إن مثل هذا التعليم يدرّبهم على التفكير المنهجي الذي يرى أن السلام لا ينفصل عن العدالة ولا عن استدامة الموارد الطبيعية.
وتمثل المشاريع التربوية التطبيقية جسرا بين النظرية والممارسة فبدلاً من الاكتفاء بالمحاضرات، يشارك الطلاب في تصميم حملات للتسامح، ووضع لوائح لمكافحة التنمّر، وتنظيم حوارات بين المجموعات المختلفة وهكذا تتحول المدارس إلى مختبرات للسلام، ويتحول المتعلم من متلقٍ سلبي إلى فاعل مشارك في تغيير بيئته الاجتماعية.
كما ينبغي توظيف الفضاء العام ووسائل الإعلام التقليدية والرقمية لخدمة هذا الهدف فالحملات الإعلامية الإيجابية، وإنتاج محتوى إبداعي يشجع على التعايش، والتغطية المتوازنة للأحداث كلها أدوات لتحويل الثقافة العامة من ثقافة صدام إلى ثقافة حوار، وبذلك تتجاوز التربية على السلام جدران الفصول لتصبح جزءا من المشهد اليومي للمجتمع.
وتعدّ الأساليب التشاركية محورا أساسيا في بناء الشخصية السلمية. فالمحاكاة ولعب الأدوار التي تسمح للمتعلمين بتقمص وجهة نظر الآخر تنمّي لديهم القدرة على التعاطف، وهو تعاطف أعمق أثراً من المواعظ النظرية وبهذا تتكون أجيال أكثر حكمة، أكثر وعياً، وأكثر ميلاً إلى البحث عن حلول غير عنيفة للنزاعات.
ولتحقيق هذا المشروع على أرض الواقع، لا بد من شراكة حقيقية بين جميع الأطراف فالدولة تضع السياسات وتوفّر الموارد، والمؤسسات التعليمية تطوّر المناهج والطرائق، والإعلام ينشر الخطاب البنّاء، ومنظمات المجتمع المدني تضطلع بتنفيذ البرامج في الميدان.
هذا التكامل يضمن أن تصبح التربية على السلام ممارسة يومية لا درسا نظريا وتبرز نتائج هذه الجهود في مبادرات ملموسة: منتديات طلابية للوساطة في النزاعات المحلية، أركان للسلام في المدارس لحل الخلافات بين الطلاب، ومهرجانات ثقافية وفنية تخفف من حدّة التوترات الهوياتية في المدن.
هذه النماذج تشهد أن التربية على السلام ليست شعارا نظريا، بل أداة عملية لإعادة بناء الثقة المجتمعية غير أن الطريق ليس سهلاً، فهناك تحديات كبرى من استقطاب سياسي وتعصب فكري وتضليل إعلامي تعرقل هذه المساعي، وكثير من الأنظمة التعليمية لا تزال تركّز على التحصيل الأكاديمي وتهمل بناء القيم والمهارات الحياتية، وهذا يفرض على القائمين على التربية أن يبتكروا أساليب جديدة، ويستعينوا بالفنون والبيانات وحملات التوعية لمواجهة خطاب الكراهية واستعادة الفضاء العام لصالح ثقافة السلام.
ولابد أخيرا من ربط الوعي العالمي بالفعل المحلي فمعرفة الطالب بما يجري من حروب وهجرات وأزمات مناخية يجب أن تنعكس على سلوكه في بيئته المباشرة: مكافحة التنمر، رفض التمييز، وحماية التعايش بين الجيران، وهكذا يتعلّم أن حفظ السلم في محيطه هو مساهمة مباشرة في السلم العالمي، وأن التفكير الكوني لا يتناقض مع العمل اليومي البسيط.
إن التربية على السلام استثمار طويل الأمد في مستقبل الإنسانية فهي تجمع بين الإيمان بإمكانية تحقيق السلام، والمعرفة بسبل الوصول إليه، والالتزام الأخلاقي بالمحافظة عليه، ومن خلال صياغة محكمة لهذا المشروع التربوي، لا نكتفي بحلم عالم خالٍ من الحروب، بل نصنع جيلاً قادرا على تحويل الحلم إلى واقع.. إنها مسيرة طويلة، لكن كل خطوة فيها – من قاعة الدرس إلى المنابر الدولية – تشكّل لبنة في بناء مستقبل أكثر عدلاً وإنسانية.
أندي هادياتو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أستاذ بجامعة جاكرتا الحكومية ورئيس رابطة أساتذة التربية الإسلامية في إندونيسيا