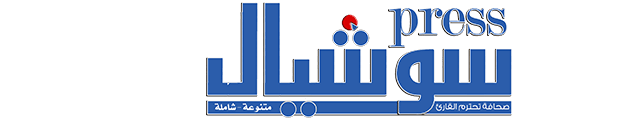هناك كثيرون مِمَّن يتصدَّرون المشهد الدَّعَوِيَّ يخلطون بين أن تمارس الدعوة، وأن تقوم بالدعاية للإسلام، وهم بذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعًا.
دستور الدعوة هو الحكمة والموعظة الحسنة. أما موادُّها فهي الإسلام كما هو بلا “مَنْتَجَة” ولا “مَكْيَجَة”. أما الدعاية فهي تجميل البضاعة في عين الزبون لتسويقها.
وما يفعله مشايخ الحنية والطبطبة هو نفس طريقة مندوب المبيعات أو البائع الجائل.
وهذا الأمر إن كان يصلح في السلع، لا يصح مع الإسلام؛ لأنهم حتى لو كانوا يُقدِّمون دعاية لتسويق الإسلام، فهي دعاية سيئة أو غير مكتملة، تندرج تحت الآية الكريمة: “أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض”، كما أنها تخالف أمر الله للعلماء “لَتُبيِّنُنَّه للناس ولا تكتمونه”، وهنا لاحِظ التأكيد في الفعل “لَتُبيِّنُنَّه” بلام التوكيد والشدتين؛ لأن الأمر خطير، وإن رآه البعض خدمة وجهادًا، ولكنهم في حقيقة أمرهم يضرون الإسلام، ومن قبله أنفسهم، كما أنه لا محل هنا لحسن النوايا.
لماذا؟ لأنني لو أعطيتُك صورة عن شخص أنه متسامح لدرجة التهاون في حقه، ثم تَبيَّنَ لك أنه ذات مرة انتصر لنفسه من ظالم، فحتمًا سيكون تَلقِّيك لتصرُّفه أنه كان يخدعك، وستدفعك صدمتك فيه للاتجاه المعاكس، رغم أنه لم يفعل سوى أخْذِ حقه؛ لأن الصورة الذهنية عنه أنه “راجل طيب”.
هذا بالضبط ما يحدث لمن يعطي أذنه لمشايخ “الشو” الإعلامي، فيُسلِّم من خلال تَلقِّيه وتلقينِه بأن الله غفور ورحيم ومسامح فقط، وعندما يبدأ في تثقيف نفسه، يكتشف أن الله شديد العقاب، فتكون الصدمة أو الشك، التي لا أدري هل هي مقصودة، أم عشوائية، لكنها في الحالين تؤدي إلى نتيجة كارثية؛ لذا تجد دائمًا آيات الرحمة والعفو مُعانِقَةً لآيات العقاب؛ لأن الإنسان مُخيَّر بين طريقين: الصواب، والخطأ، وبينهما باب العودة مفتوحًا على أقصى مصراعيه.
ولأن هناك طريقين، يختار الإنسان أحدهما بمطلق حريته؛ فبديهي أن كل طريق يُوصِّل لنهاية: إما الرحمة والعفو، وإما العقاب، وإلا لَطَغَى الناس، وتَساوَى المجرم مع الضحية.
الإسلام كالخيل العربي الأصيل، يجمع بين الرومانسية والقوة في تناغم لا يجور أحدهما على الآخر. الإسلام دين “حنيِّن” ودين رادع. والوسطية لا تعني أن تقف مفتوح القدمين بين اليمين واليسار، ولا أن تمسك العصا من الوسط، وإنما الوسطية هي التوازن، فكل شيء بقدر، كالساعة الزيادة فيها كالنقصان. والمسلم عليه أن يضبط نفسه على هذه الساعة، وليس من تلقاء نفسه، وهذا هو معنى الإسلام.. أن تُسلِم لله في كل أمورك، وتثق ثقة تامة في كل شيء أخبرك عنه، أو أمرك به، أو نهاك عنه، وستجد المنطق يوصِّلك لهذه النتيجة.
الوسطية هي الحكمة، وهي باختصار أن تضع الأمور في نصابها، ففي موضع الرحمة تكون الرحمة، وفي موضع العقاب يكون العقاب.
ولا يعني اختيارك بين الطريقين، ودعوة الله لك باختيار الحق، أن الإسلام يضع على رقاب العباد سيفًا للالتزام به، أو يُنصِّب أوصياء يُكفِّرون عن سيئات خلق الله، كما “كانت” تفعل محاكم التفتيش، وإنما يتعامل بمنطق أن هناك منهجًا لصالحك.. حاوِلْ أن تلتزم قدر الإمكان، وكلما وقعْتَ، وجدْتَ يدًا ممدودة لك لترفعك، وتُسنِدُك دون أي إكراه، وحتى لو رفضْتَها، ستظل ممدودة لك ما دامت الروح لم تخرج من الجسد؛ لأن من طبيعة الإنسان الوقوع في الخطأ؛ لأنه ليس نبيًّا ولا ملاكًا.
وهذه اليد ستُقَصِّر عليك المسافات؛ لأنها يد الله الخالق “وإن تَقرَّبَ إليَّ شبرًا؛ تقرَّبْتُ منه ذراعًا، وإن تَقرَّبَ مني ذراعًا؛ تَقرَّبْتُ منه باعًا، وإن أتاني يمشي، أتيته هَرْوَلَةً”.
هذا هو كلام رب العزة لعبده المخطئ، فما بالك المطيع؟!
والرائع في الإسلام أن أوامره في حدود أي إنسان في أي زمان ومكان؛ لأنه دين الفطرة التي خُلِقَ عليها؛ لذا فإنَّ اتباعه لا مشقة فيه؛ لأنه اتباع للإنسانية وارتقاء بهم. وكما أن من طبيعة بعض البشر المبالغة في الإجرام بشكل أذهل الشياطين، هناك عقاب يليق بخبث نفوسهم وبشاعة إجرامهم، وهو منطق طبيعي في جميع الأنظمة التي تنتهج العدل، مع فرق، وهو يد الله الممدودة لعباده وباب التوبة المفتوح بين الطريقين.