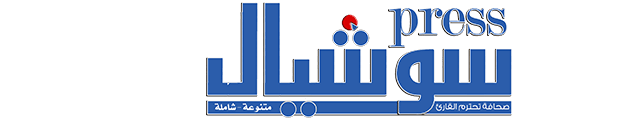اليومَ.. تحلُّ الذكرى الثامنة والأربعون لوفاة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، الكفيف الذي أنار عقول المبصرين بما أنجزه من منجزات فكرية وأدبية وعلمية تستعصي على الحصر.. ولكن السؤال: هل كان العميد كفيفًا معدوم البصر، أم ضعيف البصر، أم كان مبصرًا؟
باديء ذي بدء.. فإن أية إجابة عن هذا السؤال المركب لا تعني تجريحًا أو تشويهًا للمكانة العلمية الرفيعة التي ارتقى إليها طه حسين بجهد جهيد وعمل دؤوب نادر التكرار. عندما غيَّبَ الموتُ طه حسين في العام 1973؛ وكانت وفاته صدمة مدوية في الوسط الأدبي في مصر والمنطقة العربية بأسرها، رثاه الشاعر اللبنانيُّ الأشهرُ نـزار قباني قائلاً: آهٍ يا سيدي الذي جعل الليلَ/ نهارًا والأرضَ كالمهرجانِ/ ارمِ نظّارتيْكَ كيْ أتملَّى/ كيف تبلى شواطئُ المرجانِ/ ارمِ نظّارتيكَ ما أنتَ أعمى/ إنما نحنُ جوقةُ العميان.
هذه المرثية الحزينة لم ترُقْ لمعاصري الشاعر السوري الكبير، حيث تناوب عليه نفرٌ من الأدباء والشعراء والمفكرين العرب مُعاتبين إياه، ومُجمعين على أنَّ العميد لم يكن أعمى، كما يظنُّ العامة والدهماء وحسنو النوايا، وكما استقر في ذهن الناس ووقر في قلوبهم وضمائرهم بمرور الأيام وتعاقب السنين، حيث ارتدَّ إليه بصرُه بعد عملية جراحية ناجحة في فرنسا التي كانت تشهد نهضة مشهودة في طب العيون في هذه الفترة، وكان يومئذ في منتصف الأربعينيات من عمره تقريبًا، وكان يومئذ علمًا في رأسه نارٌ. الكاتب السوري خوري بشارة كان في صدارة مَن عارضوا “قباني”، حيث عقَّبَ على مرثيته مُندهشًا بل ساخرًا: “بل ارمِ يا نزارُ جاهليتكَ؛ كي تدركَ أنَّ طه حسين لم يكن أعمى حتى موته؛ فقد تعافى من تلك العاهة منذ أربعين عامًا، عندما سافر إلى فرنسا، وشقيقي الأكبر كان ضمن الفريق الذي أجرى له عملية إعادة البصر”، بحسب رواية الباحث محمد القوصي. صحيفة “الديار” اللبنانية التي كانت واحدة من أبرز الصحف العربية وأشهرها في ذلك الوقت دخلتْ على خط الأزمة، عندما تواصلتْ مع طبيب العيون العالمي بو خليل الكيال الذي صرَّح لها بأنه أجرى للعميد جراحة ناجحة، استرد على إثرها بصره بدرجة جيدة، وصار قادرًا على الحركة بمفرده وعلى القراءة والكتابة.
تعددت وتنوعت المعالجات الصحفية المشابهة والتي قادت في النهاية إلى أنَّ طه حسين صار مُبصرًا وقادرًا على القراءة والكتابة في منتصف عمره تقريبًا، وتحديدًا في عامه الرابع والأربعين. ويبقى سؤالٌ وجيهٌ وهو: لماذا رفض طه حسين الإفصاح عن استعادة بصره، لا سيما أن خبرًا مثل هذا كان من شأنه إسعاد محبيه ومعجبيه ومريديه الذين صاروا بالملايين في ظل تبوؤه مكانة كبيرة في المشهد الأدبي والإبداعي والعلمي منذ كتابه الصادم “في الشعر الجاهلي”، ومن بعده كتاب “مستقبل الثقافة في مصر”؟ الإجابة يمكن أن نلمسها في كتاباتٍ متناثرةٍ هنا وهناك لدى معاصري العميد الذين أجمعوا على أن الرجل- رغم موهبته الكبيرة التي لا ينكرها سوى جاحد أو حاقد أو ناقم- إلا إنه كان عاشقًا للشهرة وباحثًا عن الأضواء طول الوقت، والمواقف الدالة على ذلك أكثر من أن تُحصى، ويكفي اشتباكه الدائم و الخشن مع معظم أكابر زمانه مثل: أحمد شوقي وتوفيق الحكيم وإبراهيم المازني وغيرهم.
ومن البحث والتحري والتدقيق تبين أنَّ عددًا من أصدقاء طه حسين المقربين جدًا كانوا قد أوحَوا إليه بألا يفصح عن استعادة بصره؛ حتى لا يخسر تأييد المؤيدين وتعاطف المتعاطفين وشفقة المشفقين، لا سيما أنه كان يدين بنصف شهرته لإعاقته البصرية، وربما كان هذا تصورًا خاطئًا أو استنتاجًا متهافتًا.
في مرحلة شبابه.. انتقد طه حسين الأزهر الشريف وشيوخه، وهاجم مناهجه التعليمية، وخاضَ معاركَ عديدة مع أدباء عصره؛ فهاجم أمير الشعراء أحمد شوقي وشاعر النيل حافظ إبراهيم، كما اشتبك مع مصطفي صادق الرافعي وأحمد لطفي المنفلوطي، كما لم يعفِ صديقهِ أحمد أمين، وغيره من خصومته، وأعلن عداوته الصريحة لزكي مبارك الذي كتب في مقدمة ديوانه: “ألحان الخلود”: “لقد ظنَّ طه حسين أنه انتزع اللقمةَ مِن فم أطفالي، فليعلم حضرته أنَّ أطفالي لو جاعوا لشويتُ طه حسين وأطعمتُهم مِن لحمه، إنْ جاز أنْ أُقدِّم لأطفالي لحم الكلاب، ولكنهم لنْ يجوعوا مادامت أرزاقهم بيد الله”!!
المعركة كانت حامية الوطيس أيضًا بين طه حسين وإبراهيم عبد القادر المازني، حتى إن الأخير وصف العميد بما وصف به شعراء الجاهلية، وقال فيه: إنَّ الشك في وجود شخصية طه حسين سيكون يومًا أشبه بشك طه حسين في شخصية امرئ القيس وعنترة”. أما توفيق الحكيم فقال عن معركته مع طه حسين بعد انتهائها: إنَّ الخصومة بيني وبين طه حسين: “كانت خصومةً أدبيةً صِرف، ولكن الدكتور طه أراد أن يُقحِم فيها عنصر السياسة ليُظهِرني في صورة يهوذا ويُظهِر نفسه في صورة المسيح” وهكذا كان الوجه الآخر لطه حسين مع النخبة من مفكري ومبدعي زمانه.
ومن مصر إلى لبنان، حيث كان السجال الأدبي محتدمًا في هذه الفترة، غاص الأديب اللبناني مارون عبود في أعماق شخصية طه حسين حتى إنه كتب عنه يومًا: “لقد شبع الأستاذ الكبير والأديب العظيم مِن الثناء حتى انبشَم، وارتوى وما يزال ظمآن؛ لأنَّ الأدباءُ لا يرتوون من الثناء ولوْ عبّوه من نهر الفرات .. وإذا فاتهُ المدح، فلا بأس بالقدح، المهم أن يُذكَر، وإلاَّ فأيّ داعِ لقولهِ حين سُئل: أأنتَ قلتَ إنَّ زعامة الأدب انتقلت إلى بيروت؟ قال: لا، بل قلتُ: تُوشِك أنْ تنتقل. وهكذا نراه في جميع مواقفه لا ينسجم مع نفسه، كالجندب تقبض عليه، فيفرُّ تاركاً لك فخذه، وقد سمِعته في مواقف كثيرة يقول: أردتُ أن أغيظ المصريين، وأردتُ أن أغيظ الشباب. وقد رأيناه يثور على إمارة شوقي، ورضيَ عن عمادته هو”، والسطر الأخير يقترب أكثر من شخص طه حسين ويرسم ملامح شخصيته بدقة متناهية، كما إن عبارة: “أردتُ أن أغيظ المصريين وأغيط الشباب” تبدو دالة وكاشفة لأبعاد أخرى في شخصية العميد.
إذن..نحن بصدد شخص يحب الشهرة ويعشق الثناء ويشتهي الخلاف، ويبحث عن الاختلاف، بحسب روايات كثيرة ومتنوعة من معاصريه. اللافتُ.. أن كثيرين من معاصري ورفاق طه حسين لم يندهشوا مما تردد وانتشر بشأن تعافي بصره، بل إن بعضهم ذهب إلى التأكيد على أن الرجل كان في الأساس ضعيف البصر وليس أعمى قبل السفر إلى باريس، وهو ما أسهم في نجاح العملية الجراحية الدقيقة التي خضع لها هناك.
من المعروف والمتداول أن طه حسين وُلد مُبصرًا بإحدى قرى محافظة المنيا لأسرة ريفية فقيرة، لكنه خضع لعملية جراحية أجراها له “حلاق القرية” قبل أن يُتم عامه الخامس في عينيه؛ إثر إصابتهما بالرمد أفقدته بصره بشكل كبير! الأديب المعروف الدكتور محمد إبراهيم واحد ممن عاصروا العميد يروي شهادته عن العميد: “طه حسين لم يكن فاقد البصر بالكليّة قبل سفره إلى باريس، إنما كان يرى بصعوبة، ولذلك نجحت العملية الجراحية بسهولة بعد غرس تيارات كهربائية داخل وخارج الدماغ، وتمّ زرعها في القشرة البصرية، وهي القشرة الدماغية المسؤولة عن معالجة البيانات البصرية”.
الكاتب أحمد حسين الطماوي قال أيضًا تعليقًا على هذه الواقعة: ” فريد شحاتة سكرتير طه حسين الذي لازمه سنين عددًا أكد هذه المعلومة ولم ينفها من قريب أو بعيد”، مضيفًا: الدكتورمحمد صبري الحاصل على الدكتوراه من السوربون سنة 1919، وكان زميلاً وصديقًا لطه حسين أقرَّ واعترف أيضًا بذلك”!
يبدو أن “اللعبة” راقتْ للعميد، وتعامل معها بمهارة وإتقان شديدين، فظل مُحافظًا على هذا السر 44 عامًا أخرى حتى وافاه أجله عن 84 عامًا، بعد مسيرة علمية عظيمة، لا ينكرها أو يقلل منها سوى مغرض. وسواء قضى الرجل نصف عمره مبصرًا، أو بقى كفيفًا منذ فقد بصره وهو طفل صغير، فإنَّ هذا لا ينال من المكانة الأدبية والعلمية الشامخة التي صنعها بنفسه ولنفسه، لا سيما إذا علمنا أنه قطع شوطًا كبيرًا في حياته العلمية قبل السفر إلى باريس والخضوع للعملية الجراحية، فكان طالبًا متفوقًا في الجامعة، وباحثًا نابغة، إذ حصل على درجة الدكتوراه وهو ابن 25 عامًا، وأثار جدلاً عارمًا ولفت إليه الأنظار بكتابه “في الشعر الجاهلي”، وتدرج في المناصب الجامعية الرفيعة، واقتنصها واحدًا تلو الآخر، وربما جرَّ عليه ذلك كيد الكائدين وحسد الحاسدين، وهذه آفة أسطورية لا تفرق بين النخبة والعامة.