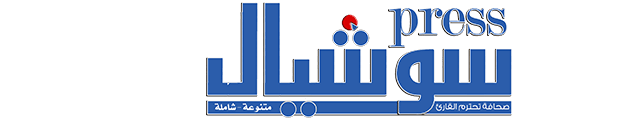العلمُ يقودُ العقولَ السليمة والقلوبَ المُطمئنة إلى سبيل الرشاد. والإسلامُ ليسَ فى خصومةٍ مع العلم، كما يردد مرتزقة التنوير؛ فما أكثرَ الآياتِ التى تُعظِّمُ من شأن العِلم، وترفعُ قدرَ العلماء. تارة يقولُ القرآنُ الكريمُ: “وقلْ ربِّ زدنى عِلماً”، وتارة يقولُ: “إنما يخشى اللهَ من عبادِه العلماءُ”. الذين فى قلوبهم مرضٌ من الملاحدة المصريين والعرب، والذين فى ريبهم يترددون، يتخذون من العلم الذى لا يصنعونه، ولكنهم يقرؤون عنه فقط، سلاحًا لإثارة الجدل العقيم، ومطيَّةً لتشكيك المؤمنين فى عقائدهم.
أما الذين يُسهمون فى حركة العلم ويصنعون تطورها، فيتضاعفُ إيمانُهم بالله الواحد القهار، وما أروعَ قولَ القرآن الكريم: “شَهِدَ اللَّـهُ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ”.
فى الوقت الذى ينشطُ فيه مثقفون ومُفكرون وكُتَّابٌ مصريون وعربٌ للترويج لأفكارٍ إلحاديةٍ وإعلان الحرب على جميع مظاهر الالتزام والتدين، بل ونَسفِ فكرةِ اتصال السماء بالأرض، نجدُ الغربَ قد أنتجَ كتابًا مُهمًا، يتغافلُ عنه الغافلون، هو: “اللهُ.. يتجلى فى عصر العلم”، وهو كتابٌ يجبُ أنْ يطلعَ عليه كلُّ من يتصدى للردِّ على كارهي الإسلام بالسليقة، سواء من خلال المراكز والوحداتِ المُخصصة لذلك بالمؤسسات الدينية، أو عبرَ الفعاليات التى يتم تنظيمها لهذا الغرضِ، حتى تكونَ فاعلة ومؤثرة وكاشفة.
الكتابُ، الذى أعدَّهُ “كريسى موريسون” ، وترجمه “محمود صالح الفلكى”، وقدَّمه وكتبَ مقدمته الدكتور “الدمرداش عبد المجيد سرحان”، وراجَعه الدكتور “محمد جمال الدين الفندى”، يتعاملُ مع حركة العلم المُتنامية والمُتغيرة، باعتبارها أدَّلة مُتجددة على إثبات أن لهذا الكون إلهًا حكيمًا، هو الذى خلقه، وهو الذى يُدبِّرُ له أمرَه، وليس العكس، كما يردد قليلو الحيلة ومعدومو الإيمان ومنزوعو العقل وذوو الضمائر الغائبة.
يقولُ الكتابُ: “إنَّ ما يريدُه السائلُ المُثقفُ عندما يسألُ عن حقيقة وجود إلهٍ لهذا الكون، لا بدَّ أنْ يكونَ مُواكبًا لأساليب ونتائج العلوم المتطورة والمتجددة”، مؤكدًا أنَّ “السائلَ يريدُ جوابًا يقومُ على استخدام المنطق السليم ويدعوه إلى الإيمان بربه إيماناً يقومُ على الاقتناع، لا على مجرد التسليم”.
مؤلفُ الكتاب وجَّه سؤاله “الشائك/ المتجدد” إلى طائفةٍ من العلماء المتخصصين في جميع فروع العلوم: الكيمياء والفيزياء والأحياء والفَلك والرياضيات والطب..وغيرها. وفى المقابل.. أجابَ هؤلاءِ العلماءُ بعقولٍ مُستنيرة على سؤال المؤلف، مُبينينَ الأسبابَ العِلمية التي تدعوهم إلى الإيمان بالله إيمانًا صادقًا، لا تنازعه الشكوكُ والأهواءُ، فأوضحوا كيف تدلُّهم قوانينُ “الديناميكا الحرارية”، على أنه لا بدَّ أنْ يكونَ لهذا الكون من “بداية”، فاذا كانَ للكون بداية، فلا بدَّ له من “مُبدئ”، من صفاته: العقلُ والإرادةُ واللانهاية.
وبحسب ما ورد فى الكتاب، فقد أجمعَ العلماءُ على أنَّ “هذا الخالقَ، لابدَّ أن يكونَ من طبيعة تُخالفُ طبيعة المادة التي تتكون من “ذرَّات”، تتألفُ بدورها من شحناتٍ أو طاقاتٍ لا يمكنُ، بحُكم العلم، أن تكونَ أبدية أو أزلية، ومن ثمَّ فلا بدَّ أنْ يكونَ هذا الخالقُ غيرَ ماديٍّ وغيرَ كثيف، ولابد أن يكونَ لطيفاً مُتناهياً في اللُّطف، خبيرًا لا نهاية لخبرته، لا تدركُه الأبصارُ وهو يُدركُ الأبصارَ، وهو اللطيفُ الخبيرُ”.
وكما جاء فى الكتاب، فإنَّ العلماءَ المُتحدثين شددوا على أنه “إذا كنا نريدُ أنْ نصلَ إلي الله، فسبيلُنا إلى ذلك لا يكونُ بحواسِّنا التي لا تستطيعُ أن ترى إلا المادياتِ الكثيفة، واذا كنا نريدُ أن نلمسَ وجودَه، فإنَّ ذلكَ لا يمكنُ أنْ يتمَّ داخلَ المعامل أو في أنابيب الاختبار، أو باستخدام المناظر المُكبِّرة أو المُقرِّبة، وإنما باستخدام العُنصر غير الماديِّ فينا مثل: العقل والبصيرة. وعلى من يريدُ أن يُدركَ آياتِ ذاته العَليَّة أن يرفع عينيه من الرُّغام، ويستخدم عقله في غير تعنُّت أو تعصُّب، ويتفكر في خلق السموات والأرض”.
يقولُ العلماءُ، كما جاءَ بالكتاب نصًّا: “إنَّ فروعَ العلم تثبتُ أنَّ هناك نظامًا مُعجزًا يسودُ هذا الكونَ، أساسُه القوانينُ والسُّننُ الكونية الثابتة التي لا تتغيرُ ولا تتبدلُ، والتي يعملُ العلماءُ جاهدين على كشفها والإحاطة بها، وقد بلغتْ كشوفنا من الدقة قدرًا يُمكِّننا من التنبؤ بالكسوف والخسوف وغيرهما من الظواهر قبل وقوعها بمئات السنين”، مُتسائلينَ: فمَن الذي سنَّ هذه القوانين وأودعها كلَّ ذرة من ذرَّات الوجود، بل في كلِّ ما هو دونَ الذرَّة عند نشأتها الأولى؟ ومَن الذي خلقَ كلَّ ذلك النظام والتوافُق والانسجام؟ ومَن الذي صمَّمَ فأبدعَ وقدَّر فأحسنَ التقديرَ”؟
يرد العلماء في هذا الكتاب على أولئك الذين يدَّعون أن الكون نشأ هكذا عن طريق “المصادفة”، فيشرحون لنا معنى “المُصادفة” ويشيرون إلى استخدام الرياضة وقوانين “المصادفة” لمعرفة مدى احتمال حدوث ظاهرة من الظواهر.
ومن الأمثلة التى وردت فى الكتاب المذكور: “إذا كان لدينا صندوقٌ كبيرٌ مليءٌ بآلافٍ عديدةٍ من الأحرُف الأبجدية، فإنَّ احتمال وقوع حرف “الألف” بجوار “الميم” لتكوين كلمة “أُمٌّ” قد يكونُ كبيراً، أمَّا احتمال تنظيم هذه الحروف لكي تكونَ قصيدة مُطوَّلة من الشعر، أو خطاباً من ابن إلى أبيه فإنه يكونُ ضئيلاً إن لم يكن مستحيلاً”.
الكتابُ نوَّهَ إلى أنَّ العلماءَ قد حَسبوا احتمالَ اجتماع الذرَّات التي يتكونُ منها جُزيءٌ واحدٌ من الأحماض الأمينية، باعتبارها المادة الأولية التي تدخلُ في بناء البروتينات واللحوم، فوجدوا أنَّ ذلك يحتاجُ إلى بلايينَ عديدة من السنين، وإلى مادَّةٍ لا يتسعُ لها هذا الكون مُترامي الأطراف. هذا لتركيب جزيءٍ واحدٍ على ضآلته، فما بالُك بأجسام الكائنات الحية جميعاً من نباتٍ وحيوانٍ، وما بالُك بما لا يُحصى من المُركَّبات المُعقدة الأخرى، وما بالك بنشأة الحياة وبملكوت السموات والأرض؟
يُجزم العلماء بأنه: “يستحيل عقلاً أن يكون ذلك قد تمَّ عن طريق المُصادفة العمياء، وأنه لا بدَّ لكل ذلك من خالقٍ مُبدعٍ عليمٍ خبيرٍ، أحاط بكلِّ شيء عِلماً وقدَّرَ كلَّ شيء ثُمَّ هَدى”.
كتابُ “اللهُ.. يتجلى فى عصر العلم” يُبيِّنُ مزايا الإيمان بالله والاطمئنان إليه والالتجاءِ إلى رحابه في الصحة والمرض، وكلما نزلتْ بالإنسان ضائقةٌ أو تَهدَّدَهُ خطرٌ أو أوشكَ أملٌ لديه أن يضيع. وقد لمسَ الكثيرونَ حلاوة الايمان في أنفسِهم، بل وضرورته لهم ولغيرهم، فتشبثوا به وحرصوا عليه حتى ذهبَ بعض العلماء إلى أنَّ بالإنسان حاجة بيولوجية تدفعه إلى الإيمان بالله.. “فطرَة الله الّتي فَطرَ الناسَ عَلَيها”.
ليسَ ذلك فحسب، بل إنَّ الكتاب يُبينُ كيفَ أنَّ الإيمانَ باللهِ هو أصلُ الفضائل الاجتماعيَّة والأخلاقيَّة والإنسانيَّة جميعاً، فبدون هذا الإيمان يصبح الإنسانُ غالباً حيوانًا تحكمُه الشهوة ولا يردُّهُ ضميرٌ!