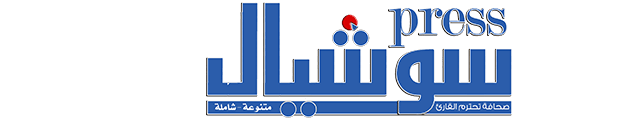في طفولتي كانت رحلة القطار من نجع حمادي إلى القاهرة أشبه بمغامرة طويلة، نافذة مفتوحة على حياة الناس؛ الرحلة التي لا تقل عن ثماني ساعات كانت تمر بسرعة بين عينيّ الصغيرتين.
كنت أجلس بجوار النافذة، أتابع البيوت المتناثرة تمر سريعًا، وأتساءل عن الأسرار والخبايا التي تخفيها تلك الجدران، وأراقب الوجوه العابرة في المحطات، أتأمل الناس وكأنهم كتاب مفتوح، أخلق من ملامحهم قصصًا وأبني حكايات لا تنتهي. كان القطار بالنسبة لي نافذة على حياة لم أكن أعيشها، وسيلة للهرب من الواقع الصغير في قريتي إلى عالم أوسع وأكثر غموضًا.
كنت أرى في كل وجه حكاية، وفي كل محطة فصلًا جديدًا.. لماذا يبتسم هذا الرجل؟ ماذا تحمل تلك المرأة؟ هل تلك الفتاة التي تلوح بيدها تنتظر شخصًا عزيزًا؟ كانت الأسئلة تملأ رأسي الصغير، ولم أكن أملّ من البحث عن إجابات في عيون الناس.
لكن مع مرور السنوات، تغيرت الرحلة.. تلك الساعات الثماني التي كانت تمر كلمح البصر صارت ثقلًا أحاول تجاوزه بالنوم. أصبحت النافذة مجرد زجاج يفصلني عن عالم لم أعد أريد أن أراه، صارت الشوارع والبيوت مجرد مشاهد باهتة، والوجوه التي كنت أبحث فيها عن الأمل لم تعد تثير فضولي؛ بل صارت تحمل همومًا أعرفها جيدًا. في عيون الناس لم أعد أرى قصصًا ممتعة، بل أعباءً تشبه عبئي.
أصبحت أؤمن أن «من راقب الناس مات همًا».. لم أعد أبحث عن قصص الآخرين، لأنني أدركت أن لكل شخص حِملًا يخفيه خلف نظراته. تلك الطفولة التي كانت ترى في القطار رحلة استكشاف، صارت اليوم ترى فيه مجرد طريق طويل يجب أن ينتهي.
الرحلة ذاتها، لكن النظرة اختلفت؛ كأن القطار نفسه تغيّر. رغم أن المسافة بين نجع حمادي والقاهرة لم تقصر، لكن القلب صار مثقلًا، ولم يعد يرى العالم ببراءة طفل يتأمل الناس ليصنع حكايات. الآن، أغمض عينيّ في السفر، كمن يحاول الهروب من همومه، أو ربما من هموم الآخرين التي لم يعد قادرًا على حملها أيضًا.